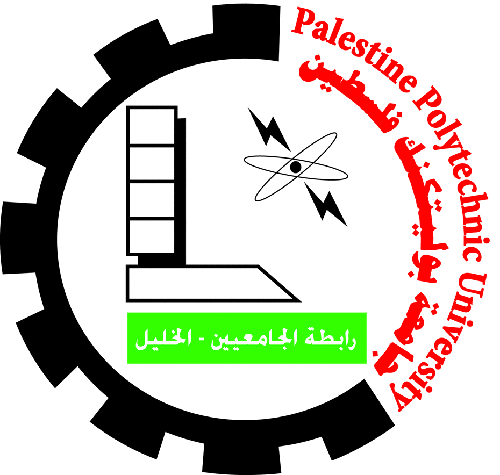وجهة نظر: الريادة أن أصنع من الموجود ما هو مفقود.
الكاتب: أ. صخر سالم المحاريق.
ضمن تداول المفاهيم بين النظرية والتطبيق في صناعة أثر حقيقي، ومن باب الاستلهام في صياغة وجهة نظري الخاصة أعلاه كعنوان في التعبير عن مفهوم للريادة؛ كفكرة وصفة مجردة تمثل الخصائص الأساسية للشيء الذي تمثله، استوقفني بإعجابٍ وتمعن شعار: " أن الريادة لا تحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام"، والذي أطلقه مركز الملكة رانية العبد الله للريادة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، الذي نظم ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي والتي جابت نشاطاته وجالت العديد من الدول في أصقاع الأرض وبقاعها ومنها أردننا الغالي، ولو عدنا بالزمن للوراء قليلاً؛ لوجدنا أن الملك الحسين بن طلال رحمه الله، كان من أوائل من تحدثوا عن مفهوم التنمية في الوطن العربي، وكان ذلك في بداية سبعينيات القرن الماضي، وقد خطى في هذا النهج إقداماً وأقداماً مباركة. ولكون الأردن من البلدان العربية النامية، والتي تفتقر للمصادر الطبيعية كالدول النفطية على سبيل المثال، ركّز العاهل الأردني رحمه الله على التنمية في عدة قطاعات منها التعليمي والصحي، ما جعل الأردن يتصدر قائمة السياحة العلاجية، كأحد الحاجات والمرتكزات التنموية لأي بلد، والتي أصبحت عنواناً ونموذجاً يقتدى به، فأسس نواةً لبناء صرحٍ صحي رائد، ألا وهو مدينة الحسين الطبية، وهي بذلك أول مدينة عربية تملك رؤية العمل الريادي في المجال الصحي، واستحق بخطواته الريادية والتنموية تلك لقب (الباني)، وكان بذلك ممن صنع من الموجود ما هو مفقود فعلياً، في ربوع الأردن العزيز، وعلى صعيد وطننا العربي الحبيب إلى يومنا هذا.
إن ريادية الأفكار والأفعال عزيزي القارئ؛ كانت دوماً نتاج أشخاصٍ واعين ومدركين لذواتهم ولأهدافهم، ولحاجات مجتمعاتهم ودورهم فيها، فريادية أي عملٍ أو فعلٍ هو في البداية مبادرةُ شخصٍ واحدٍ، يحمل فكرة كالسراج الوهاج تضيئ للآخرين سرمدة الطريق، فغاندي وشبه القارة الهندية الفقيرة، ومنديلا وابرتهايد جنوب أفريقيا، وميهاتير محمد وماليزيا، ولي كوان وسينغافورة، وكوبا الجيفارية، ما هي إلا شاهد حقيقي على أفكار أشخاصٍ أناروا الطريق وشحذوا الهمم، ولو توقفنا هنيهة عند مقولة غاندي: "يجب أن تكون أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم"، لوجدنا معناً عميقاً لما نتحدث عنه من مبادرات فردية وجماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لميهاتير محمد وتجربته الماليزية في التنمية، والذي أضحى صانعُ مجدها، ورائدُ تجربتها حين قال: "إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تحدث بين عشيةٍ وضحاها، وعلى الناس أن يتحركوا لإحداثها"، فلو أمعنا النظر قليلاً في كلتا المقولتين والنماذج سابقة الذكر، لوجدنا أن هناك نقطة بداية يمثلها شخص، ونقطة نهاية تمثلها مجموعة من الأفراد المتأثرين بالفكرة، الحاملين لها والحالمين بها، في اطار مجتمعي متعاون كخلية النحل، لتصبح فيما بعد الهاماً كتجاربٍ ونماذجٍ للتعميم والتقليد من قبل الآخرين.
ولو توقفنا برهةً من الزمن، لصياغةِ مفهوماً للريادة، باعتبارها صفة وسمة؛ تعني التميز والمبادرة والابداع، لوجدنا أن هذا المفهوم يمثله شخصُ الفاعل وهو الإنسان الريادي كموصوف، وتميز الفعل أو العمل كنتيجة ذات تأثير ايجابي، فهي من وجهة نظري؛ ترتكز على الانسان كمحور للتغيير، ونقطة انطلاق للوصول لذلك التميز فعلاً ونتيجةً، ومن أجل خلق ذلك التميز، يجب علينا بناء الانسان القادر على التفكير والتجديد، لخلق تلك الأفعال والأعمال، فهي تحتاج في صياغة تكوينها البنائي إلى "تكوين فكري معرفي" أي؛ قدرٌ من المعرفة المتخصصة بالشيء، إضافة إلى "تكوين سلوكي قيمي"؛ يستحقُ رائدها وسامَ الاتصافِ بها، بمعنى آخر؛ هي بحاجة لتفكيرٍ سليمٍ مقترنٍ بالعمل، ولسلوكٍ إيجابي تحركه قيمٌ وعقائدٌ جازمة تجاه ذلك التفكير، وهذا العمل يستندُ لمنظومةٍ قيمية وأخلاقية ما، تقودُ الانسان نحو التغيير والتطوير، والخروج من نمطية الأشياء إلى قولبة الأفكار، وصناعة المحتمل من المستحيل، وقد أسلفت في مقالةٍ سابقةٍ أن الريادةَ مفهومٌ عامٌ؛ يعني التميز والتفرد في الشيء، والذي يصنعُ طريقاً من التأثير الايجابي تجاه الأشياء الأخرى، في مفردها وفي مجموعها، وهذا المفهوم اذا ما أردنا تخصيصه في مجال معين، فهذا يعني تميزٌ وحصرية في هذا المجال، أو تلك الصفة وذاك الموصوف، وتمثلُ في نتيجتها ما يضيفه ويصنعه الشخص الريادي من الموجود لما هو مفقود، عبر مبادرته للتغير، فهنالك ريادة الأعمال، والريادة الاجتماعية، والريادة في المجال العسكري، والرياضي، والصناعي، والعلمي، والطبي، ...الخ، ولكلٍ منها رائدٌ ورواد والشواهد كثيرة، فخلف كل اكتشاف واختراع، ومقولة ونظرية، رواد يمثلهم اسم فاعل هم: المكتشف، والمخترع، والقائل، والمنظر.
لطالما آمنت - وما زلت - بأن التعليم هو سلم الحضارة، درجاته: التخطيط، والتفكير الواعي المستند إلى المعرفة، وخطواته: "العمل ثم العمل ثم العمل"، ونتاجه: الريادة والتنمية في كافة المجالات، وأن تشغيل العقل هو الطريق الصحيح لفهمنا لمجتمعاتنا، بدءً بالذوات وانتهاءً بالجماعات، لأن فهمنا لذواتنا هو المنطلق السليم لفهمنا لمحيطنا، فمعرفتنا لأنفسنا هي الطريق لبناء قدراتنا، وتنمية مهاراتنا، وبالتالي تحقيق أهدافنا، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، فالتفكير السليم والواعي المخطط له جيداً، والمقترن بالعمل هو الطريق المعبد للتحضر والرقي بكافة أشكاله، وصوره الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية ...الخ، وهذا ما تؤكده مقولة نيلسون مانديلا: (التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم)، ولو فكرنا قليلاً في مقولة منديلا متسائلين هل قالها من باب التنظير فقط؟ أم وضع كيفية للتطبيق استندت إلى قوله: "بأن الرؤية من دون تنفيذ مجرّد حلم، والتنفيذ من دون رؤية مجرّد مضيعة للوقت، أما الرؤية والتنفيذ مجتمعان، فيمكن أن يغيرا العالم".
ولعل مسوغة الوهم عزيزي القارئ التي تفترض: "بأن المعرفة أو المعارف يمكن نقلها وترجمتها وتعليمها من ثنايا الكتب فقط"، على اعتبار أن هذه هي حدودها وهي ثابت للقياس عند البعض، لا شك بأنها هي من يقف عائقاً أمام تنمية التكوين الفكري والسلوكي للشخص، وبالتالي ريادية مجتمعاتنا العربية وتطورها وأخذها لزمام المبادرة، فالمعرفة من وجهة نظري "إن هي إلا بيانات تصفها معلومات مترابطة لتفسير علاقات ما، تجمعت تحت احتمالية الصواب والخطأ بالتجربة الشخصية أو الجماعية، تقودنا إلى فهم جزئي أو كلي حول الأشياء ونؤكدها عبر برهان يبن صحة طرحها"، إذ يمكننا وصفها أيضاً: بأنها معلوماتٌ ومهاراتٌ مكتسبة، كنتيجة لتفاعلك مع ظروف الزمان والمكان بمكوناته البشرية والمادية، وتعززها تجربتك الشخصية أو تجربة الآخرين عبر الملاحظة والاكتساب بالمراس، وتراكماتها عبر الوقت بالممارسة المتكررة، تقودك لتصبح متمرساً أو على وجه أدق خبيراً قادراً على وزن الأمور، ووضعها في موضعها السليم، وبالتالي إطلاق أحكام صحيحة حول الأشياء والظواهر، لأن تراكمية المعرفة والمهارات عبر الوقت يمكن تسميتها "بالخبرة" النابعة من صحة التفكير، وسلامة التنفيذ والعمل، وهذا ما تؤكده تجربة سنغافورة الريادية، من خلال مبدأ التجربة والخطأ في تطبيق السياسات الاقتصادية، وتقييمها في نهضتهم التنموية والتي اعتبرت نموذجاً يحتذى به كمقياس ومعيار للنجاح.
ومن هذا المنطلق إذا ما أردنا صناعة ريادة حقيقية في مجتمعاتنا، فيجب علينا ألا نغفل أهمية التعليم والثقافة في صياغة وصقل كلا التكوينين السابقين، وأقصد هنا الفكري والسلوكي للفرد لاكتساب تلك المعرفة، فكل منهما يقود للآخر ويؤثر فيه بعلاقة تكاملية لا تضادية، فالتكوين السلوكي مثلاً يبدأ منذ نشأة الانسان طفلاً، وتكون هنا نقطة البداية هي الأسرة المؤسسة الأولى والأم في أي مجتمع، فما يكتسبه الفرد من منظومة إسمية وقيمية ومعرفية حول الأشياء المحيطة به، على اختلاف الظرفية الزمانية والمكانية، إن هي في مجموعها إلا معايير أخلاقية تحدد أفكاره وسلوكياته وتوجهاته للتكيّف والبناء والقبول المجتمعي، ومن أجل بناء ذلك السلوك المثالي لإيجاد فرداً ايجابياً منتجاً مجتمعياً، يجب علينا إيجاد منظومة تعليمية مستمرة يتطور فيها الفرد فكرياً وسلوكياً، وذلك على امتداد مراحله العمرية المختلفة كنوع من التعليم مدى الحياة، ولا زلنا نفتقر في تنشئتنا إلى المهارات الحياتية من مهارات للتفكير والتفكير الناقد، ومهارات الاتصال الفعال، والتعاطف وكسب التأييد، والتحكم بالذات وادارة الوقت، وادارة المشكلات، وصياغة الأهداف وقياس تحققها، والتي هي في نظري ما يقود الى شخص ريادي ومبادرٍ قادرٍ على التغيير والابداع، إضافة الى المعلومة المكتسبة من باب التجربة والتطبيق، وهو ما سيقود في النهاية الى إشغال وإعمال العقل بكل ما هو مفيد، بهدف تعزيز نتيجة حقيقية وفعلية ذات تأثير ايجابي، فمرور الفرد بمعادلة التجربة، فالإدراك، فالاتجاه، فقيمة ومعتقد يقود إلى الثقافة والمعرفة المعممة مجتمعياً كنتيجة، هو ما يصنع الفارق فيما نقول لصقل ذلك الفكر والسلوك الفردي والجماعي المنتمي والمبادر.
ولو رجعنا للتجارب التنموية والنماذج سابقة الذكر، لوجدنا انها انطلقت بالإنسان ومن خلاله، فكانت إستراتيجية ماليزيا للتنمية ترتكز في جوهرها على بناء الإنسان، من أجل تحقيق تنميةٍ شاملة، ومن خلال تكوين سلوكي يعمل على تعميق الوعي والحرص الداخليّين لدى كل فردٍ في الدولة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأفراد لأن ذلك سيُولّدُ لديهم شعوراً بأنهم عناصر حقيقية وفاعلة في البناء والتنمية، فكانت رؤية البلد التنموية مبنيّة على " تأسيس مجتمعٍ قيميٍّ كامل، يتحلى فيه المواطنون بمستوى رفيعٍ من القيمِ والمعايير الأخلاقية، والتي تقود لتكوين سلوكي قويم ومثالي، يؤسس لوعي ثقافي تنمويي تجاه المجتمع، ولقد شكل التعليم في سنغافورة المفتاح الحقيقي للانتقال للعالم الأول والمنافسة الاقتصادية العالمية من خلال الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، ورغم محدودية الموارد الطبيعية في سنغافورة وافتقارها للعديد منها، وهذا يثبت قطعياً أن الريادة هي امكانيات بشرية صانعة للأفكار، حيث ركز "لي كوان" كرائد وصانع للتجربة السنغافورية في التنمية، على إعادة روح الإيمان لأبناء دولته، من خلال دفعهم نحو التعلم والعمل، من أجل إيجاد وطن يفتخرون في الانتماء له جميعاً، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، وتعد الخطوة الأولى التي انطلق منها، هي إيجاد نظام تعليمي متميز في محاوره المختلفة: من منهاجٍ بنّاء، ومدرسٍ بأسلوبٍ عصري مجدد، وبيئة تعليمية متكاملة ومتصلة بحاجات المجتمع، تبدأ بالأسرة وتنتهي بمؤسسة العمل، فالأثر المجتمعي الكلي نحو الرفاه والتقدم في كافة المجالات وهذا ما يؤكد صدق المعادلة السابقة، فجميع التجارب السابقة الذكر اعتمدت على الموجود في بلادها لصناعة المفقود، وإن كان قليلاً، ونهضت بالإنسان لكي تنهض بالتنمية الشاملة. وفي خلاصة القول أشيدُ مرةً أخرى بشعار أن الريادة بحاجة إلى إقدام كما أن هذا الإقدام هو الذي يصنع من الموجود ما هو مفقود، فالإنسان هو منطلق الريادة ومن خلاله تبدأ، وهو جوهر التنمية ومن خلاله وبه تتم، مهما كانت امكانات البلد المتاحة فريادة الأفكار هي نتيجة حتمية لخلق البدائل، وصناعة الحلول الابداعية، ولقد أعجبني ذلك الإفريقي حين وجد الحل لفائض مياه الأمطار، بأن قام بحصرها بأكياس رملية على شكل سبخات منفصلة، يستخدمها أهل قريته بعد انحسار الامطار لعدة اشهر كمياه للشرب، والاستخدام المنزلي، وبعد جفافها صيفاً تبقى أرض السبخات رطبة فيستغلونها في الزراعة الى حين هطول الامطار على نحو دوري، لعل هذا مثالاً حقيقياً بأن الريادة تبدأ بالإنسان، وما يصنعه هو نتيجة لفكرة ما وليس لإمكانيات فقط، ولعل المانيا شاهداً آخر في نهضتها المعجزة باحتفاظها بمخزون يعتبروه كنز ألمانيا الحقيقي من الوثائق والموسوعات في مختلف العلوم، تحت جبل من الجرانيت في مكان سري على عمق 100م تحت الأرض، لدرجة أن لكل بيت في ألمانيا خارطة بشكله، وهذا ما أعاد بناء هامبورغ ودرسدن بعد أن سويتا بالأرض، وفي نهاية الأمر أؤكد أن الإنسان العربي الأصيل والمنتمي هو الموجود الذي لا زال مفقوداً لبناء نهضتنا العربية مرة أخرى في ظل هذا الابتعاد الطويل عن الماضي التليد والمستقبل المنشود لنهضة تعيد توجيه بوصلتها العقول النيرة.
الكاتب: أ. صخر سالم المحاريق.
ضمن تداول المفاهيم بين النظرية والتطبيق في صناعة أثر حقيقي، ومن باب الاستلهام في صياغة وجهة نظري الخاصة أعلاه كعنوان في التعبير عن مفهوم للريادة؛ كفكرة وصفة مجردة تمثل الخصائص الأساسية للشيء الذي تمثله، استوقفني بإعجابٍ وتمعن شعار: " أن الريادة لا تحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام"، والذي أطلقه مركز الملكة رانية العبد الله للريادة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، الذي نظم ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي والتي جابت نشاطاته وجالت العديد من الدول في أصقاع الأرض وبقاعها ومنها أردننا الغالي، ولو عدنا بالزمن للوراء قليلاً؛ لوجدنا أن الملك الحسين بن طلال رحمه الله، كان من أوائل من تحدثوا عن مفهوم التنمية في الوطن العربي، وكان ذلك في بداية سبعينيات القرن الماضي، وقد خطى في هذا النهج إقداماً وأقداماً مباركة. ولكون الأردن من البلدان العربية النامية، والتي تفتقر للمصادر الطبيعية كالدول النفطية على سبيل المثال، ركّز العاهل الأردني رحمه الله على التنمية في عدة قطاعات منها التعليمي والصحي، ما جعل الأردن يتصدر قائمة السياحة العلاجية، كأحد الحاجات والمرتكزات التنموية لأي بلد، والتي أصبحت عنواناً ونموذجاً يقتدى به، فأسس نواةً لبناء صرحٍ صحي رائد، ألا وهو مدينة الحسين الطبية، وهي بذلك أول مدينة عربية تملك رؤية العمل الريادي في المجال الصحي، واستحق بخطواته الريادية والتنموية تلك لقب (الباني)، وكان بذلك ممن صنع من الموجود ما هو مفقود فعلياً، في ربوع الأردن العزيز، وعلى صعيد وطننا العربي الحبيب إلى يومنا هذا.
إن ريادية الأفكار والأفعال عزيزي القارئ؛ كانت دوماً نتاج أشخاصٍ واعين ومدركين لذواتهم ولأهدافهم، ولحاجات مجتمعاتهم ودورهم فيها، فريادية أي عملٍ أو فعلٍ هو في البداية مبادرةُ شخصٍ واحدٍ، يحمل فكرة كالسراج الوهاج تضيئ للآخرين سرمدة الطريق، فغاندي وشبه القارة الهندية الفقيرة، ومنديلا وابرتهايد جنوب أفريقيا، وميهاتير محمد وماليزيا، ولي كوان وسينغافورة، وكوبا الجيفارية، ما هي إلا شاهد حقيقي على أفكار أشخاصٍ أناروا الطريق وشحذوا الهمم، ولو توقفنا هنيهة عند مقولة غاندي: "يجب أن تكون أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم"، لوجدنا معناً عميقاً لما نتحدث عنه من مبادرات فردية وجماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لميهاتير محمد وتجربته الماليزية في التنمية، والذي أضحى صانعُ مجدها، ورائدُ تجربتها حين قال: "إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تحدث بين عشيةٍ وضحاها، وعلى الناس أن يتحركوا لإحداثها"، فلو أمعنا النظر قليلاً في كلتا المقولتين والنماذج سابقة الذكر، لوجدنا أن هناك نقطة بداية يمثلها شخص، ونقطة نهاية تمثلها مجموعة من الأفراد المتأثرين بالفكرة، الحاملين لها والحالمين بها، في اطار مجتمعي متعاون كخلية النحل، لتصبح فيما بعد الهاماً كتجاربٍ ونماذجٍ للتعميم والتقليد من قبل الآخرين.
ولو توقفنا برهةً من الزمن، لصياغةِ مفهوماً للريادة، باعتبارها صفة وسمة؛ تعني التميز والمبادرة والابداع، لوجدنا أن هذا المفهوم يمثله شخصُ الفاعل وهو الإنسان الريادي كموصوف، وتميز الفعل أو العمل كنتيجة ذات تأثير ايجابي، فهي من وجهة نظري؛ ترتكز على الانسان كمحور للتغيير، ونقطة انطلاق للوصول لذلك التميز فعلاً ونتيجةً، ومن أجل خلق ذلك التميز، يجب علينا بناء الانسان القادر على التفكير والتجديد، لخلق تلك الأفعال والأعمال، فهي تحتاج في صياغة تكوينها البنائي إلى "تكوين فكري معرفي" أي؛ قدرٌ من المعرفة المتخصصة بالشيء، إضافة إلى "تكوين سلوكي قيمي"؛ يستحقُ رائدها وسامَ الاتصافِ بها، بمعنى آخر؛ هي بحاجة لتفكيرٍ سليمٍ مقترنٍ بالعمل، ولسلوكٍ إيجابي تحركه قيمٌ وعقائدٌ جازمة تجاه ذلك التفكير، وهذا العمل يستندُ لمنظومةٍ قيمية وأخلاقية ما، تقودُ الانسان نحو التغيير والتطوير، والخروج من نمطية الأشياء إلى قولبة الأفكار، وصناعة المحتمل من المستحيل، وقد أسلفت في مقالةٍ سابقةٍ أن الريادةَ مفهومٌ عامٌ؛ يعني التميز والتفرد في الشيء، والذي يصنعُ طريقاً من التأثير الايجابي تجاه الأشياء الأخرى، في مفردها وفي مجموعها، وهذا المفهوم اذا ما أردنا تخصيصه في مجال معين، فهذا يعني تميزٌ وحصرية في هذا المجال، أو تلك الصفة وذاك الموصوف، وتمثلُ في نتيجتها ما يضيفه ويصنعه الشخص الريادي من الموجود لما هو مفقود، عبر مبادرته للتغير، فهنالك ريادة الأعمال، والريادة الاجتماعية، والريادة في المجال العسكري، والرياضي، والصناعي، والعلمي، والطبي، ...الخ، ولكلٍ منها رائدٌ ورواد والشواهد كثيرة، فخلف كل اكتشاف واختراع، ومقولة ونظرية، رواد يمثلهم اسم فاعل هم: المكتشف، والمخترع، والقائل، والمنظر.
لطالما آمنت - وما زلت - بأن التعليم هو سلم الحضارة، درجاته: التخطيط، والتفكير الواعي المستند إلى المعرفة، وخطواته: "العمل ثم العمل ثم العمل"، ونتاجه: الريادة والتنمية في كافة المجالات، وأن تشغيل العقل هو الطريق الصحيح لفهمنا لمجتمعاتنا، بدءً بالذوات وانتهاءً بالجماعات، لأن فهمنا لذواتنا هو المنطلق السليم لفهمنا لمحيطنا، فمعرفتنا لأنفسنا هي الطريق لبناء قدراتنا، وتنمية مهاراتنا، وبالتالي تحقيق أهدافنا، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، فالتفكير السليم والواعي المخطط له جيداً، والمقترن بالعمل هو الطريق المعبد للتحضر والرقي بكافة أشكاله، وصوره الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية ...الخ، وهذا ما تؤكده مقولة نيلسون مانديلا: (التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم)، ولو فكرنا قليلاً في مقولة منديلا متسائلين هل قالها من باب التنظير فقط؟ أم وضع كيفية للتطبيق استندت إلى قوله: "بأن الرؤية من دون تنفيذ مجرّد حلم، والتنفيذ من دون رؤية مجرّد مضيعة للوقت، أما الرؤية والتنفيذ مجتمعان، فيمكن أن يغيرا العالم".
ولعل مسوغة الوهم عزيزي القارئ التي تفترض: "بأن المعرفة أو المعارف يمكن نقلها وترجمتها وتعليمها من ثنايا الكتب فقط"، على اعتبار أن هذه هي حدودها وهي ثابت للقياس عند البعض، لا شك بأنها هي من يقف عائقاً أمام تنمية التكوين الفكري والسلوكي للشخص، وبالتالي ريادية مجتمعاتنا العربية وتطورها وأخذها لزمام المبادرة، فالمعرفة من وجهة نظري "إن هي إلا بيانات تصفها معلومات مترابطة لتفسير علاقات ما، تجمعت تحت احتمالية الصواب والخطأ بالتجربة الشخصية أو الجماعية، تقودنا إلى فهم جزئي أو كلي حول الأشياء ونؤكدها عبر برهان يبن صحة طرحها"، إذ يمكننا وصفها أيضاً: بأنها معلوماتٌ ومهاراتٌ مكتسبة، كنتيجة لتفاعلك مع ظروف الزمان والمكان بمكوناته البشرية والمادية، وتعززها تجربتك الشخصية أو تجربة الآخرين عبر الملاحظة والاكتساب بالمراس، وتراكماتها عبر الوقت بالممارسة المتكررة، تقودك لتصبح متمرساً أو على وجه أدق خبيراً قادراً على وزن الأمور، ووضعها في موضعها السليم، وبالتالي إطلاق أحكام صحيحة حول الأشياء والظواهر، لأن تراكمية المعرفة والمهارات عبر الوقت يمكن تسميتها "بالخبرة" النابعة من صحة التفكير، وسلامة التنفيذ والعمل، وهذا ما تؤكده تجربة سنغافورة الريادية، من خلال مبدأ التجربة والخطأ في تطبيق السياسات الاقتصادية، وتقييمها في نهضتهم التنموية والتي اعتبرت نموذجاً يحتذى به كمقياس ومعيار للنجاح.
ومن هذا المنطلق إذا ما أردنا صناعة ريادة حقيقية في مجتمعاتنا، فيجب علينا ألا نغفل أهمية التعليم والثقافة في صياغة وصقل كلا التكوينين السابقين، وأقصد هنا الفكري والسلوكي للفرد لاكتساب تلك المعرفة، فكل منهما يقود للآخر ويؤثر فيه بعلاقة تكاملية لا تضادية، فالتكوين السلوكي مثلاً يبدأ منذ نشأة الانسان طفلاً، وتكون هنا نقطة البداية هي الأسرة المؤسسة الأولى والأم في أي مجتمع، فما يكتسبه الفرد من منظومة إسمية وقيمية ومعرفية حول الأشياء المحيطة به، على اختلاف الظرفية الزمانية والمكانية، إن هي في مجموعها إلا معايير أخلاقية تحدد أفكاره وسلوكياته وتوجهاته للتكيّف والبناء والقبول المجتمعي، ومن أجل بناء ذلك السلوك المثالي لإيجاد فرداً ايجابياً منتجاً مجتمعياً، يجب علينا إيجاد منظومة تعليمية مستمرة يتطور فيها الفرد فكرياً وسلوكياً، وذلك على امتداد مراحله العمرية المختلفة كنوع من التعليم مدى الحياة، ولا زلنا نفتقر في تنشئتنا إلى المهارات الحياتية من مهارات للتفكير والتفكير الناقد، ومهارات الاتصال الفعال، والتعاطف وكسب التأييد، والتحكم بالذات وادارة الوقت، وادارة المشكلات، وصياغة الأهداف وقياس تحققها، والتي هي في نظري ما يقود الى شخص ريادي ومبادرٍ قادرٍ على التغيير والابداع، إضافة الى المعلومة المكتسبة من باب التجربة والتطبيق، وهو ما سيقود في النهاية الى إشغال وإعمال العقل بكل ما هو مفيد، بهدف تعزيز نتيجة حقيقية وفعلية ذات تأثير ايجابي، فمرور الفرد بمعادلة التجربة، فالإدراك، فالاتجاه، فقيمة ومعتقد يقود إلى الثقافة والمعرفة المعممة مجتمعياً كنتيجة، هو ما يصنع الفارق فيما نقول لصقل ذلك الفكر والسلوك الفردي والجماعي المنتمي والمبادر.
ولو رجعنا للتجارب التنموية والنماذج سابقة الذكر، لوجدنا انها انطلقت بالإنسان ومن خلاله، فكانت إستراتيجية ماليزيا للتنمية ترتكز في جوهرها على بناء الإنسان، من أجل تحقيق تنميةٍ شاملة، ومن خلال تكوين سلوكي يعمل على تعميق الوعي والحرص الداخليّين لدى كل فردٍ في الدولة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأفراد لأن ذلك سيُولّدُ لديهم شعوراً بأنهم عناصر حقيقية وفاعلة في البناء والتنمية، فكانت رؤية البلد التنموية مبنيّة على " تأسيس مجتمعٍ قيميٍّ كامل، يتحلى فيه المواطنون بمستوى رفيعٍ من القيمِ والمعايير الأخلاقية، والتي تقود لتكوين سلوكي قويم ومثالي، يؤسس لوعي ثقافي تنمويي تجاه المجتمع، ولقد شكل التعليم في سنغافورة المفتاح الحقيقي للانتقال للعالم الأول والمنافسة الاقتصادية العالمية من خلال الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، ورغم محدودية الموارد الطبيعية في سنغافورة وافتقارها للعديد منها، وهذا يثبت قطعياً أن الريادة هي امكانيات بشرية صانعة للأفكار، حيث ركز "لي كوان" كرائد وصانع للتجربة السنغافورية في التنمية، على إعادة روح الإيمان لأبناء دولته، من خلال دفعهم نحو التعلم والعمل، من أجل إيجاد وطن يفتخرون في الانتماء له جميعاً، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، وتعد الخطوة الأولى التي انطلق منها، هي إيجاد نظام تعليمي متميز في محاوره المختلفة: من منهاجٍ بنّاء، ومدرسٍ بأسلوبٍ عصري مجدد، وبيئة تعليمية متكاملة ومتصلة بحاجات المجتمع، تبدأ بالأسرة وتنتهي بمؤسسة العمل، فالأثر المجتمعي الكلي نحو الرفاه والتقدم في كافة المجالات وهذا ما يؤكد صدق المعادلة السابقة، فجميع التجارب السابقة الذكر اعتمدت على الموجود في بلادها لصناعة المفقود، وإن كان قليلاً، ونهضت بالإنسان لكي تنهض بالتنمية الشاملة. وفي خلاصة القول أشيدُ مرةً أخرى بشعار أن الريادة بحاجة إلى إقدام كما أن هذا الإقدام هو الذي يصنع من الموجود ما هو مفقود، فالإنسان هو منطلق الريادة ومن خلاله تبدأ، وهو جوهر التنمية ومن خلاله وبه تتم، مهما كانت امكانات البلد المتاحة فريادة الأفكار هي نتيجة حتمية لخلق البدائل، وصناعة الحلول الابداعية، ولقد أعجبني ذلك الإفريقي حين وجد الحل لفائض مياه الأمطار، بأن قام بحصرها بأكياس رملية على شكل سبخات منفصلة، يستخدمها أهل قريته بعد انحسار الامطار لعدة اشهر كمياه للشرب، والاستخدام المنزلي، وبعد جفافها صيفاً تبقى أرض السبخات رطبة فيستغلونها في الزراعة الى حين هطول الامطار على نحو دوري، لعل هذا مثالاً حقيقياً بأن الريادة تبدأ بالإنسان، وما يصنعه هو نتيجة لفكرة ما وليس لإمكانيات فقط، ولعل المانيا شاهداً آخر في نهضتها المعجزة باحتفاظها بمخزون يعتبروه كنز ألمانيا الحقيقي من الوثائق والموسوعات في مختلف العلوم، تحت جبل من الجرانيت في مكان سري على عمق 100م تحت الأرض، لدرجة أن لكل بيت في ألمانيا خارطة بشكله، وهذا ما أعاد بناء هامبورغ ودرسدن بعد أن سويتا بالأرض، وفي نهاية الأمر أؤكد أن الإنسان العربي الأصيل والمنتمي هو الموجود الذي لا زال مفقوداً لبناء نهضتنا العربية مرة أخرى في ظل هذا الابتعاد الطويل عن الماضي التليد والمستقبل المنشود لنهضة تعيد توجيه بوصلتها العقول النيرة.
• أكاديمي ومختص بالتنمية المستدامة والموارد البشرية.